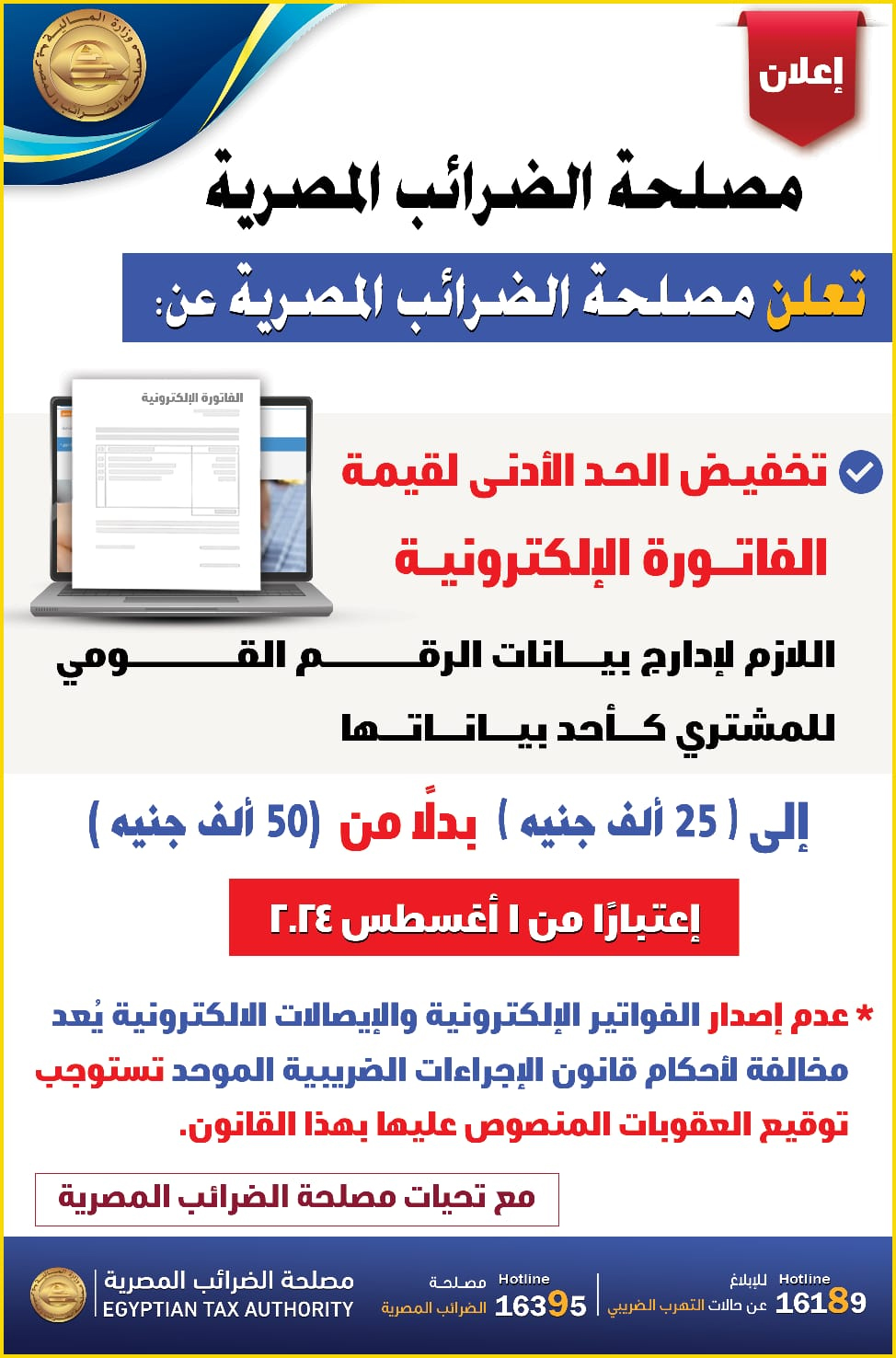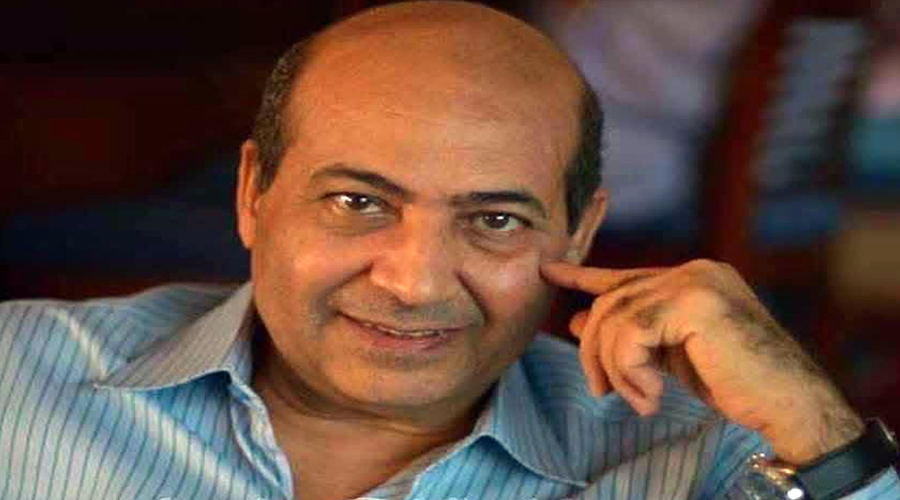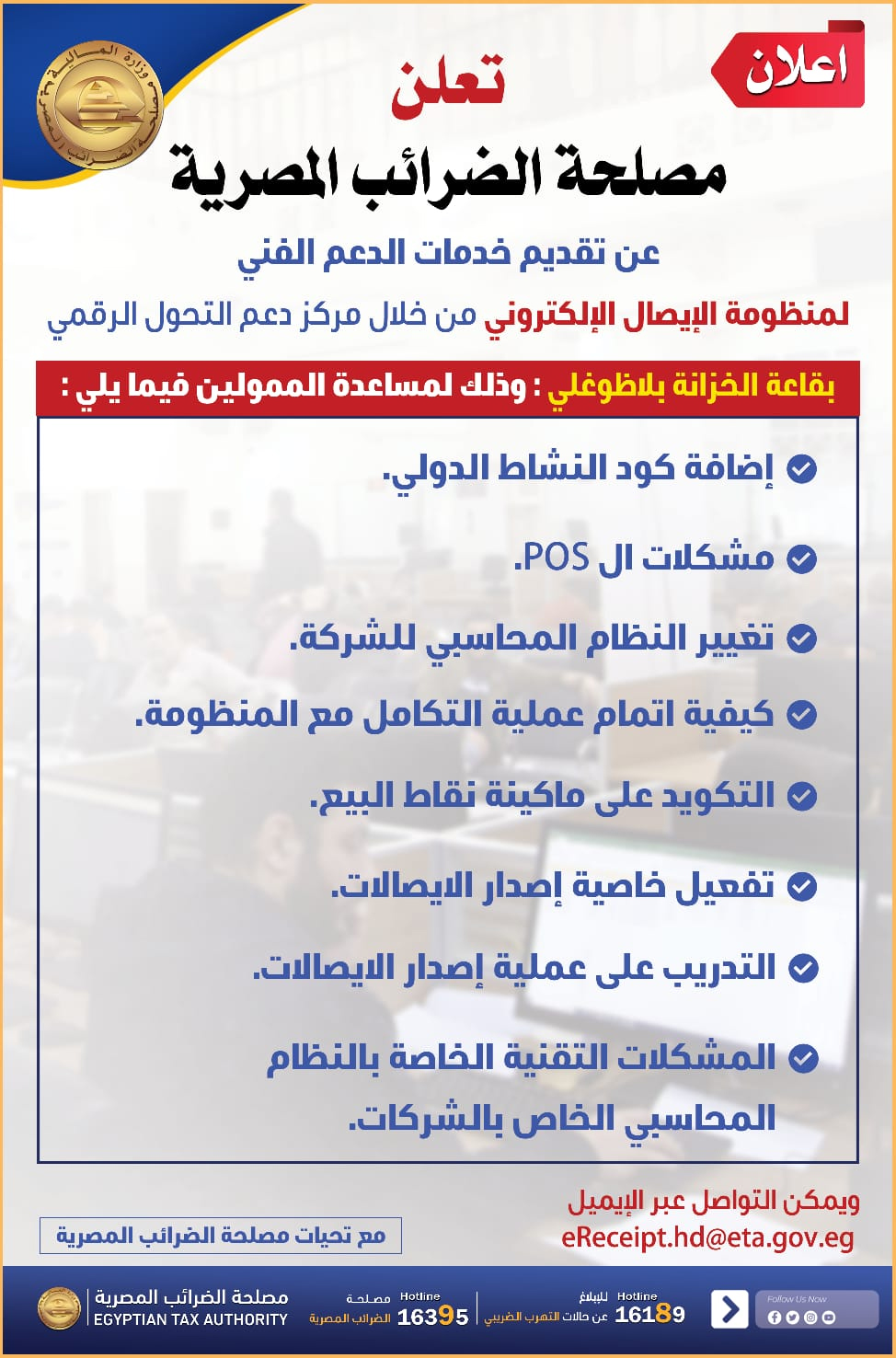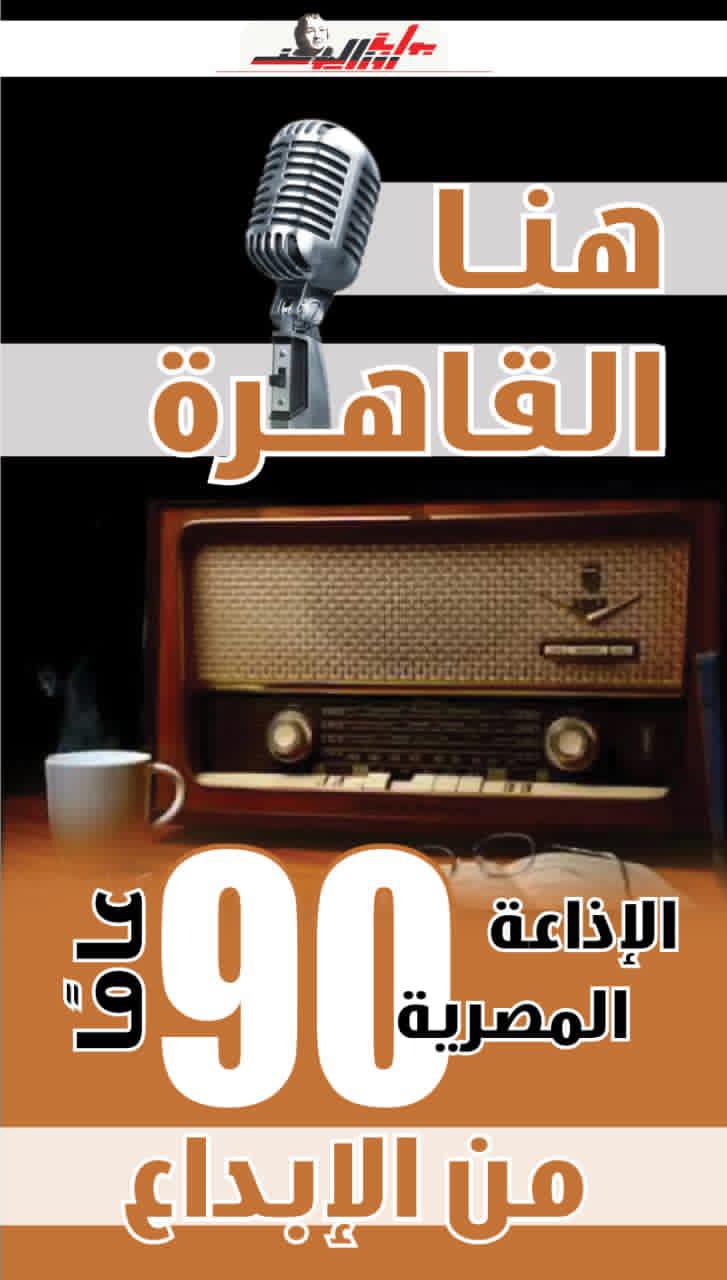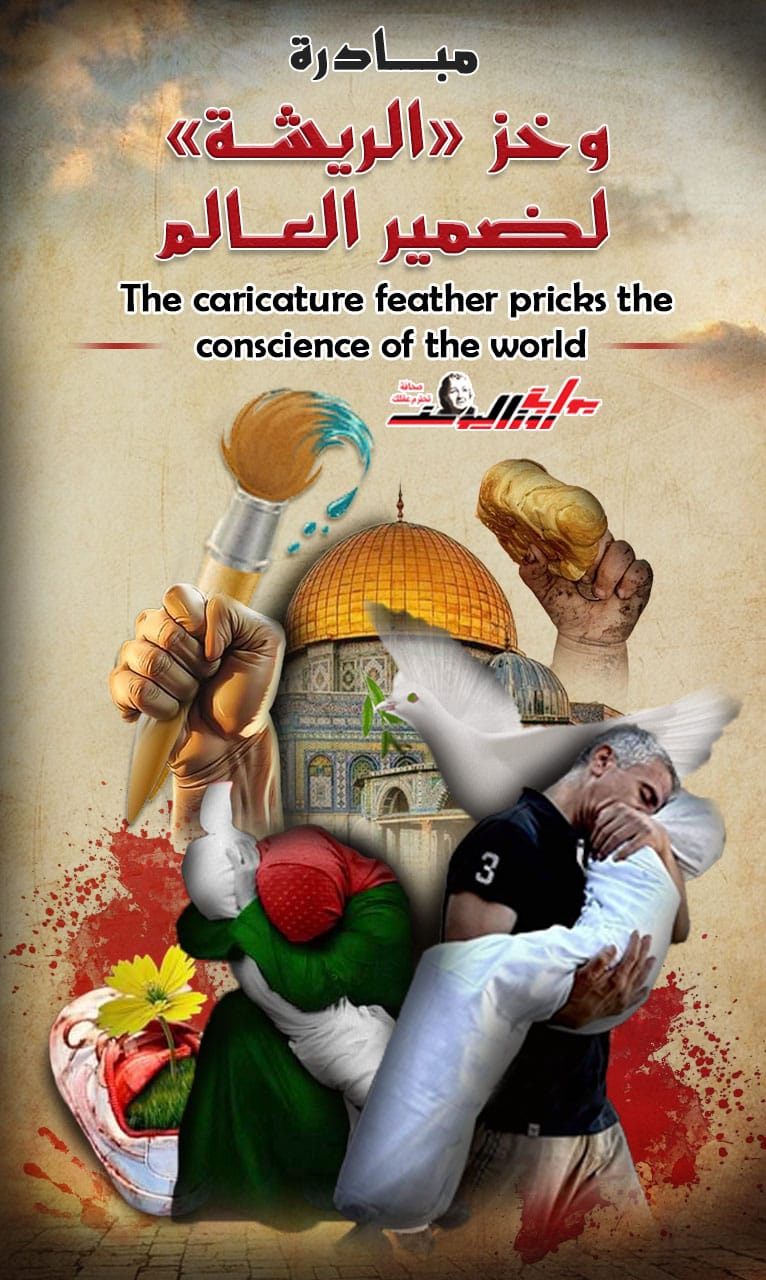د. شيماء فرغلي تكتب: المرأة المفتية في الحضارة الإسلامية

شهدت العصور الوسطى مشاركة المرأة المسلمة في الحياة العلمية والأدبية والثقافية في الحضارة الإسلامية. فالمتصفح لكتب التاريخ والتراجم يجد مئات النساء اللاتي ساهمن بنصيب وافر في الحياة الثقافية ومثلّن قاعدة علمية متسعة التأثير في مجالات عدة في الحياة العلمية، لذا وجدنا النساء الفقيهات والمفتيات والمحدِّثات والأديبات والشاعرات… إلخ.
واتحدث هنا عن المرأة المفتية في الحضارة الإسلامية، إذ حرصت النساء على التعلم للتفقه في أمور دينهم ودنياهم فبرزت المحدثات الفقيهات اللاتي مارسن الإفتاء، فقد ذكر ابن القيم أن الذين حُفظت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله ﷺ تجاوزوا المائة والثلاثين ما بين رجل وامرأة، وذكر في مقدمتهم أم المؤمنين عائشة، وتوالى بعد ذلك ظهور المفتيات في مختلف البلدان وعلى مدى عصور التاريخ الإسلامي، واكتسبن من الصفات العلمية والخلقية التي أهلتهنّ للمساهمة في استنباط الأحكام والإدلاء برأيهنّ فيما يعرض عليهن من مسائل، حتى نصت المصادر على أن الواحدة منهنّ كانت "تفتي"، في أزمان كانت غلبة الإفتاء فيها للرجال.
فكما وصفت كتب التاريخ والتراجم الكثير من النساء أنهنّ كنّ فقيهات أو محدثات للحديث النبوي الشريف، وصفت البعض منهنّ أنهنّ مفتيات، حيث وجدنا أعدادًا محدودة جدًا من النساء كنّ من أهل الفتوى والمعرفة الفقهية الواسعة، والقدرة العقلية التي تستطيع القياس واستنباط الأحكام من أدلتها الشرعية. وربما تعود هذه الأعداد المحدودة التي ذكرتها المصادر من المفتيات إلى طبيعة المجتمع الإسلامي في العصور الوسطى، الذي لم يكن يميل في الغالب إلى قيام المرأة بهذا الدور. لأن الإفتاء يحتاج إلى مواجهة مباشرة مع الناس، الأمر الذي أدى إلى عزوف النساء اللاتي وصلن إلى درجة العلم بالفقه عن القيام بالإفتاء. وذلك رغم مشاركة بعضهنّ للمفتين من ذوي قرابتهنّ في التعلم والحصول على الإجازات العلمية خاصة في الأسر التي نبغ فيها عدد من المفتين كأسرة ابن شريعة اللخمي في الأندلس، ومنهم فاطمة بنت محمد بن شريعة اللخمي التي شاركت أخاها المفتي أبا محمد الباجي الإشبيلي (القرن 4هـ/10م) في بعض شيوخه، وقد يصل الأمر في بعض الأسر العلمية إلى إغفال ذكر اسم المرأة والاكتفاء بإلحاق صلة القرابة بينها وبين الأخ أو الأب أو الزوج مثلما حدث مع الفقيهة أخت إسماعيل بن يحيى المُزَني (توفيت 264هـ/878م) التي كانت تحضر مجلس الشافعي في مصر وكانت تروي له عن الشافعي فلم يحب تسميتها وأغفل ذكر اسمها فكانت لا تُعرف إلا بـ"أخت المُزَني". ورغم أن شهرة أسرهنّ قد غطت على شهرتهنّ إلا أن علمهنّ بالفقه والفتوى انعكس على أسرهنّ بصورة او بأخرى.
ونلاحظ هذا الأمر كذلك في عصرنا الحديث إذ لا نجد المرأة المفتية إلا على هامش محدود في حركة الإفتاء في العالم الإسلامي، وخلو المؤسسات الرسمية للإفتاء من وجود مفتيات نساء، رغم أن الشروط الواجب توافرها فيمن يتقلد وظيفة الإفتاء هي العدل والبلوغ سواء كان رجلا أو امرأة.
وقد كان هناك عدة عوامل أدت إلى ظهور بعض المفتيات في مختلف البلدان الإسلامية كمصر والعراق والقيروان والأندلس خلال عصور التاريخ الإسلامي مثل عامل التنشئة في كنف الأسر العلمية الذي أدى في بعض الأوقات إلى تفوقهنّ على الأسر التي نشأن فيها، وعامل المكان مثل انتقال المرأة للعيش في أماكن مزدهرة بالعلوم الدينية والدنيوية فتكتسب العلوم التي تؤهلها للإفتاء. ونتناول فيما يلي بعضًا من هذه العوامل:
كان لعامل التنشئة الأسرية للمرأة أثره الواضح في تكوينها العلمي والثقافي؛ بأن تنشأ المرأة في بعض الأسر العلمية كأن يكون والدها أو زوجها عالمًا، أو تكون ابنة عالم وتتزوج من عالم فتتوافر أسباب تحصيل العلم والوصول إلى درجة الإفتاء، فنجد على سبيل الريادة أم المؤمنين "عائشة بنت أبي بكر الصديق"؛ إذ كان لنشأتها في بيت النبوة وزواجها في سن مبكر من رسول الله ﷺ، أثره الكبير في كثرة مروياتها من الأحاديث والأحكام الفقهية، فتقدمت في العلم والفرائض والأحكام والحلال والحرام واجتهدت في استنباط الأحكام للوقائع التي لم تجد لها حكما في الكتاب والسنة، وأصبحت مرجعًا لأصحاب رسول الله ﷺ فيستفتونها ويجدون لديها الحل لما أُشكل عليهم. وكذلك خديجة بنت سحنون بن سعيد التنوخي (توفي 270هـ/883م) التي أخذت العلم عن أبيها حامل لواء مذهب مالك بالمغرب. ووصلت إلى درجة من العلم جعلت أبيها يستشيرها في أهم أموره حتى أنه لما عُرض عليه القضاء لم يقبله إلا بعد أخذ رأيها. وكانت فاطمة بنت أحمد بن يحيى (توفيت 840هـ/1436م) تستنبط الأحكام الشرعية وتتباحث مع والدها في المسائل الفقهية حتى شهد لها والدها فقال: إن فاطمة ترجع إلى نفسها في استنباط الأحكام. وكان زوجها الإمام المطهر يرجع إليها فيما يُشكل عليه من مسائل وكان يدخل عليها فيستفتيها إذا أُشكل عليه أمر أثناء تقريره الدرس لتلاميذه، فترشده إلى الصواب، ثم يخرج إليهم فيشرح لهم ما أُشكل عليهم، فيقولون: ليس هذا منك بل من خلف الحجاب. ويقصدون بذلك زوجته فاطمة.
ويتضح من ذلك التميز الكبير الذي أهّل بعض المفتيات اللاتي كنّ يعيشنّ في كنف العلماء سواء كان الوالد أو الزوج إلى استشارتهنّ والأخذ برأيهنّ، ويؤكد ذلك أيضًا ما يرويه لنا المقّري في كتابه نفح الطيب من أن زوجة قاضي لوشة، وهي إحدى المدن الأندلسية، فاقت العلماء في معرفة الأحكام والنوازل التي هي المسائل الفقهية، وكان في مجلس قضائه تنزل به النوازل، فيقوم إليها فتشير عليه بما يحكم به.
وقد تبلغ المفتية من العلم مبلغًا يجعلها ترد الخطأ الذي قد يقع فيه زوجها في الفُتيا، وهذا ما حدث مع المفتية فَاطِمَة بنت علاء الدين السَّمرقَنْدِي (توفي 580هـ/1184م) التي حفظت مؤلف أبيها (تحفة الفقهاء)، إضافة إلى أنها تزوجت من أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكَاسَاني، وهو أحد علماء عصره الكبار، ويُلقب بملك العلماء صاحب كتاب (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع)، فكانت تَردهُ إِلَى الصَّوَاب وتعرّفه وَجه الخطأ في الْفتيا فَيرجع إِلَى قَوْلهَا. ولما حرص المفتين على كتابة الفتاوى للتأكيد على مسؤوليتهم عن الفتوى، والرغبة الكبيرة في وصولها بشكل دقيق للمستفتي. فكَانَت الْفَتْوَى تخرج بتوقيع فاطمة وتوقيع أَبِيهَا السَّمرقَنْدِي، وعندما تزوجت بالكَاسَاني كَانَت الْفَتْوَى تخرج بِتوقيعاتهم الثلاثة.
وكان لعامل المكان تأثير كبير في وصول بعض المفتيات إلى درجة الإفتاء فحينما انتقلت عائشة بنت يوسف الباعونية الدمشقية إلى القاهرة عام 911هـ/1505م "اقتطفت فيها حظًا وافرًا من العلوم حتى أجيزت بالإفتاء والتدريس" وقامت بتصنيف العديد من المؤلفات، إذ كانت القاهرة في تلك الفترة مزدهرة في العلم والتعليم حتى قال عنها ابن خلدون: "إنما العلم والتعليم هنا بالقاهرة من ديار مصر".
وتنوعت الصفات التي وصفت بها المفتيات بين الصفات العلمية والخلقية، إذ كان الخلق والعلم، وخصوصا العلوم الدينية كالحديث والفقه، هما مدار العمل بالفتوى، ولذا جاء وصف المصادر لبعض المفتيات من الناحية العلمية بأوصاف مثل "من ربات العقل والرأي والعلم"، و"أفقه نساء الأمة"، و"أحفظ الناس للفقه"، و"فقيهة"، و"متفقهة بالدين"، و"محدثة"، و"عالمة فاضلة"، و"عالمة جليلة"، و"عالمة بالفقه والفرائض" و"أديبة عظيمة القدر"، و"شاعرة كبيرة"، ووصفت بعضهن من الناحية الخلقية بصفات مثل: "من خيار الناس"، و"من أحسن النساء وأعقلهن"، و"فاضلة"، و"من فواضل نساء عصرها"، و"صالحة عابدة" و"ذات دين وصلاح".
تنوعت موضوعات الفُتيا التي كانت تفتي فيها النساء المفتيات، فمنهنَ من كانت تفتي في الفقه بوجه عام مثل: أم عيسى بنت إبراهيم بن إسحاق الحربي (توفيت 328ه/940م)، ومنهنّ من كانت تفتي في مسائل معينة من مسائل الفقه وتميزت بها حتى أُخذت عنها مثل أخت المُزَني التي نقل عنها الفقيه الشافعي أبو القاسم الرافعي في زكاة المعدن، وفاطمة بنت أحمد بن يحيى التي كانت تتباحث مع والدها في مسائل فقهية كمسألة الخضاب بالعصفر، أما أكثر ما كانت تفتي فيه المُفتيات هي الأمور المرتبطة بالنساء مثل: خديجة بنت سعيد التنوخي التي استفتاها نساء عصرها في مسائل الدين. وكانت قدوة صالحة لهن في معضلات الأمور، وزليخا بنت إسماعيل بن يوسف الشافعي التي كانت تفتي في مسائل الحَيض، وكذلك فاطمة بنت محمد بن مكي العاملي التي كان أبوها (المتوفى عام 786ه/ 1384م) يثني عليها ويأمر النساء بالاقتداء بها والرجوع إليها في أحكام الحَيض والصلاة.
واشتهرت بعض النساء بآراء فقهية وفتاوى استقلت بها مثل: أم المؤمنين عائشة التي انفردت بفتوى عدم التفريق بين ولد الزنا وغيره في إمامة الصلاة ما دام هو الأقرأ لكتاب الله والأفقه في الشرع، إذْ ترى أنه "ليس عليه من خطيئة أبويه" عملًا بقوله تعالى: ﴿وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام:164].
تعددت مذاهب الإفتاء التي مارست الفتوى من خلالها بعض الفقيهات حتى أن بعضهنّ تركنّ بصمات واضحة فيها مثل: فَاطِمَة بنت علاء الدين السَّمرقَنْدِي التي كَانَت تنقل الْمَذْهَب الحنفي نقلًا جيدًا، وكذلك أمة الواحد بنت القاضي أبي عبد الله الحسين بن إسماعيل الضبي (توفيت 377هـ /987م) التي كانت من أحفظ الناس للفقه على مذهب الشافعيّ. ورغم ذلك فإن كتب الفقه أهملت ذكر الأقوال الفقهية لهؤلاء العالمات عدا أقوال أمهات المؤمنين وبالأخص عائشة، ولم نعرف الكثير منهنّ إلا من خلال كتب التاريخ والتراجم والتي أهملت ذكر مذاهب الإفتاء الخاصة بهنّ في كثير من الأحيان.
ولما كانت الفتوى تمثل النتيجة الكبرى للفقه والثمرة المرجوة من كتاباته المختلفة، يمكن التعرف على حركة التأليف الفقهي من ناحية علاقته بالفتاوى في بعض مؤلفات المفتيات التي شكلت أساسًا في تكوين ثقافتهم الإفتائية، فنجد في القرن السادس الهجري فاطمة بنت محمد بن أحمد السمرقندي التي تركت مؤلفات عديدة في الفقه والحديث على نحو ما تذكر زينب فواز في كتابها (الدر المنثور في طبقات ربات الخدور).
وشكلت بعض فتاوى وأقوال المفتيات أساسًا تعليميًا ومعرفيًا للفقهاء عمومًا والمفتين خاصة؛ وهو الأمر الذي دعى كبار الأئمة لتجميعها ووضعها في مصنف خاص بها، ويمثل ذلك قيام الإمام الزركشي (توفي 794هـ/1392م) بتجميع الاستدراكات التي قامت بها أم المؤمنين السيدة عائشة على فتاوى كبار الصحابة ووضعها في مصنف بعنوان: "الإجابة لما استدركت عائشة على الصحابة".
ولم تقتصر بعض مؤلفات المفتيات على الفقه أو الحديث وحدهما، ولكنها اتسمت بالتنوع في موضوعات متنوعة تدل على ثقافة واسعة، وهو ما يتضح في المؤلفات المتعددة لعائشة بنت يوسف الباعونية (توفيت 922هـ/1516م) وهي: (الإشارات الخفية في المنازل العلية)، و(الدر الغائص في بحر المعجزات والخصائص)، و(صلات السلام في فضل الصلاة والسلام)، و(الفتح المبين في مدح الأمين)، و(قصيدة في البديع)، و(الملامح الشريفة والآثار المنيفة).
ويتضح من العرض السابق الدور الذي قامت به المرأة في الإفتاء منذ القرن الأول للهجرة، ورغم الأعداد المحدودة التي قامت بالإفتاء عبر عصور التاريخ الإسلامي، إلا أنه أصبح لهنّ حضور مميز ظهر في عدة معالم منها:
1- الأخذ برأيهنّ ومشورتهنّ خصوصًا لمن نشأت منهنّ في أسرة علمية، فقد بلغ بعضهنّ مبلغًا من العلم جعلها تصحح وترد الخطأ عن كبار العلماء في وقتها.
2- الإفتاء في موضوعات متنوعة أبرزها المسائل الفقهية المرتبطة بالنساء، إضافة الى شهرة بعض النساء بآراء فقهية وفتاوى استقلت بها.
3- المساهمة في حركة التأليف الفقهي المرتبط بالفتاوى التي شكلت بعضها أساسًا تعليميًا ومعرفيًا للفقهاء عمومًا والمفتين خاصة، إذ قامت بعضهنّ بوضع مصنفات اتسمت بالتنوع ودلت على ثقافة فقهية ومعرفية واسعة، والبعض الآخر جُمعت أقوالهنّ وفتاويهنّ بعد وفاتهنّ بفترات طويلة في مصنفات لازالت باقية حتى الآن.
ورغم هذا الحضور والتميز الكبير للمفتيات إلا أنّ الكثير منهن كن يقمن بالفتوى من وراء حجاب ومن خلال أقاربهن كالوالد أو الزوج حتى من تصدرت في التدريس والإفتاء منهنّ لم تكن ضمن الإطار المؤسسي الرسمي للإفتاء في تلك العصور، وهو ما نجد ظلاله الآن في عصرنا الحديث إذ تخلو المؤسسات الرسمية للإفتاء من مفتيات رغم بلوغ الكثيرات درجة كبيرة من العلم بالفقه تؤهلهنّ للقيام بالإفتاء.
باحثة في التاريخ والحضارة الإسلامية